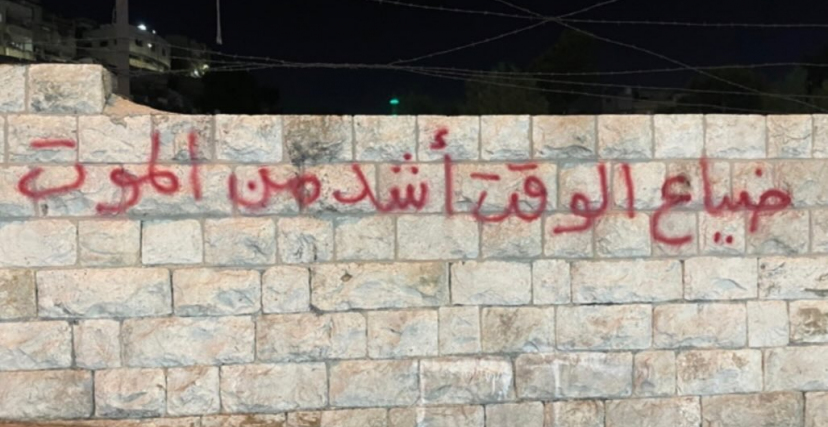"ليش صافنة؟، يسألك الناس، وتفقد تركيزك لوهلة. يذكرك سؤالهم بأنك ربما من فرط السماع لهم، لم تعد تسمع لهم، أو بأنك ربما من فرط انغماسك في المكان، صرت في مكان آخر، وأن أفكارك أخذتك إلى مكان مختلف.
من بين كل الأسئلة التي رافقتني، كان هناك سؤال وواحد شغلني أكثر: ما الذي يجعل إنسانًا يشعر بالاستقرار وهو يعيش في حالة انتظار مستمرة؟
بدأت الثورة في سوريا سنة 2011، ومعها بدأ النظام بقمع وتهجير ملايين السوريّين, وانتهى الآلاف منهم في الأردن. سافروا، هاجروا، غادروا، هربوا، لجأوا، لا يبدو هذا مهمًا الآن، أو على الأقل لا تبدو اللغة التي قضينا وقتًا طويلًا مهمومين بها، الأكثر أهمية بالنسبة لهم.
كلمة لجوء كانت جديدة على لسانهم. وكذلك كانت كلمة لاجئين. سجّلوا أنفسهم في مفوضيّة اللاجئين، وأخدوا هذه الصفة مؤقًا، أو هكذا كان يُفترض، وصاروا بين يوم وليلة، على الأقل في الأوراق، لاجئين. صفة كان يُفترض أن تكون مؤقتة، لكن 11 سنة مرت، ومعظم من جاؤوا بقوا.
سافرت منذ سنة إلى الأردن لأبدأ العمل الميداني من أجل أطروحة الدوكتوراه في الأنثروبلوجيا التي أعمل عليها. من بين كل الأسئلة التي رافقتني، كان هناك سؤال وواحد شغلني أكثر: ما الذي يجعل إنسانًا يشعر بالاستقرار وهو يعيش في حالة انتظار مستمرة؟
هذا السؤال الذي كان يتعلق بطبيعة الحال بوضع السوريين في البلد الجديد، أخذني إلى أماكن عديدة؛ من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، ومن المدن إلى الأرياف والمخيمات. دفعني هذا السؤال إلى سماع قصص ناس كثيرين. قصص بدأت في سوريا واكتملت في أماكن أخرى. قصص عن الماضي، عن الحاضر، عن المستقبل. قصص مرتبطة بسياسات وبحكومات وبمنظمات. قصص مرتبطة بأقارب وبأصدقاء وبأماكن وأوقات مختلفة.
وبالطبع، ولدت هذه القصص أسئلة أخرى: كيف يؤثر تصنيف الأمم المتحدة للاجئين على ظروف الحياة اليومية للسوريّين في الأردن؟ أقصد ما هي معايير "الضعف" (Vulnerability) والحاجة والحق في المساعدات والخدمات الإنسانية التي تحكم بدورها طريقة الحياة اليومية للاجئ، وتولد بالتالي أنواعًا وتصنيفات جديدة من "الضعف". من اللاجئ الذي يستحق المساعدة ومن الذي لا يستحق؟
إعادة التوطين، أو إمكانية التنقل من الأردن لدولة أخرى بطريقة نظامية، واحدة من أهم الخدمات الإنسانية بالنسبة للسورييّن في الأردن. وكانت موضوعًا رئيسيًا في كثير من لقاءاتي ومقابلاتي مع الناس. عندما سألتهم عن الأحقية والأهلية، من هو المؤهل لإعادة التوطين؟ لم يكن هناك جواب محدد. "حظ" قالوا لي. الموضوع "عشوائي" قالوا. قلة وضوح وعدم وجود جواب دفعت الناس لمحاولة فهم أهلية وشروط المفوضية، وربما الخضوع لها، لكن بلا جدوى. وهو ما أدى إلى محاولات للسفر خارج آليات المفوضية.
بعد سنين من الانتظار المفتوح، الانتظار الذي ليس له نهاية، حاول كثيرون أخذ مسألة السفر على عاتقهم. هذه المحاولات دفعت المفوضية في الأردن لنشر عدة إعلانات وتصريحات على جميع وسائل التواصل الاجتماعي. في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 نشرت المفوضية فيديو إعلاميًا عبر موقعها في فيسبوك عن التنقل غير النظامي وحذرت من خطر هذا النوع من التنقل، كما حذرت أن من يغادر الأردن بشكل غير نظامي سيخسر تصنيفه المعترف به دوليًا كلاجئي، وكذلك الحماية والخدمات التي يكفلها هذا التصنيف. ولكن، هل يشعر من ينتظر منذ 10 سنوات السفر النظامي من خلال المفوضيّة، بحمايتها أو وجود خدماتها؟ الواضح من خلال دراستي الميدانية هو أن وعود إعادة التوطين الباهتة، وقلة الوضوح والشفافية، والانتظار اللا نهائي، أدت كلها إلى ما تحذر منه المفوضية؛ محاولات وطرق أخرى للتنقل. إذا كان تصنيف اللاجئ لا يكفل للنّاس الحماية والحقوق التي وعدت الحكومات والأمم المتحدة بتوفيرها، فخسارة تصنيف اللاجئ لا تبدو خسارة لمن يقرر المغادرة.
كانت هذه المحاولات ما دفعني إلى الانخراط في بعض قصص الناس الذين قابلتهم. أحيانا كان دوري صغيرًا، أحيانا أكبر. ساعدت أحيانًا في تحضير رسالة أو تسليم ورقة لسفارة ما، أحيانًا في التحضير للسفر. ساعدت ربما بأمور بسيطة مثل تسليم هدية من شخص في مكان لشخص في مكان آخر. ربما أمور أخرى أكبر، مثل تحضير مقابلات تأشيرة أو حتى وجودي في مواعيد مع مؤسسات مختلفة.
مهما كان دوري صغيرًا، كان يكفيني أحيانًا أن أشعر أنني جزء بسيط من بعض القصص. قصص لمست قلبي وأثرت فيّ بعمق. لا أتحدث عن وجع أو إحباط فقط، ولكن عن فرح، توتر، أمل، خوف، حزن، يأس وحماس. أتحدث عن التأرجح بين كل هذه المشاعر.
الشرود أيضًا. عندما أتذكر بداية تجربتي في الدراسة الميدانية، كيفية تفكيري، أشعر أن ثمة ما تغير. ربما أملي، طاقتي وحتى قدرتي على الاندماج في القصص التي أسمعها.
أتذكر مرة أنني قمت بمقابلة عن إعادة التوطين، وكان شاب يشرح لي كيف حاول حماية نفسه من إحباط رفض السفر. قال لي "الحياة لا ترحم الناس الورديين". قال لي إن تفكيره بالسفر خارج الأردن كان ورديًا ولم يكن واقعيًا. اسأل نفسي الآن، هل كنت وردية في بداية دراستي الميدانية؟ ولو كنت وردية، ما الذي تغير؟ أعرف أني لم أكن وردية، ولكن حتى لو كان هذا السؤال بلاغيًا، فهو يصف الطريقة التي نتغير فيها كأنثربولوجيين خلال العمل الميداني.
في الواقع، فإن القصص التي سمعتها والقصص التي شاركت فيها خلال هذه الفترة لم تولد فقط أسئلة عن حياة من يعيشون حالة لجوء طويلة في الأردن، لكنها ولدت أيضًا أسئلة عن دوري كباحثة وإمكانياتي والافتراضات بأنني يجب أن أكون منفصلة عن الحقل، أو موضوعية. داخل المجال الأكاديمي، هناك من يتحدث دائمًا عن الموضوعية، عن قدرة الباحث على فهم الظواهر دون الانغماس فيها. ولكن، كأي إنسان، إذا كان الباحث منخرطًا مع الناس، في حياتهم وقصصهم، فكيف يمكن له أن يكون حياديًا؟ عندما تؤثر القصص عليه، عندما يحاول المساعدة، عندما يدفع لقاء بشخص إلى شخص آخر، أو عندما يسأل من نعمل معهم أسئلة لم تكن قد خطرت في بالنا؟ كيف يمكن أن نكون موضوعيين؟ كيف يمكن اعتبار عدم الانخراط في أوجاع الناس وقضاياهم أكثر مصداقية، وكيف يمكن للحياد البارد أن يحظى بشرعية علمية أكبر؟
في النهاية، فإن قصص الناس ليست مجرد قصص. إنها ظروف اقتصادية، ظروف اجتماعية، ظروف تاريخية وسياسية محلية ودولية. قصص الناس هي الحياة اليومية، والحياة اليومية ليست مفصولة عن السياسة أو الاقتصاد أو التاريخ أو المجتمع أبدًا. أنا أيضًا جزء من "الناس"، وأنا أيضًا عندي قصتي. فكيف يمكن أن يكون موقفي منفصلًا عنهم؟
"ليش صافنة يا هانا؟"
شردت للحظة. أفكاري أخدتني لقصة ما. شو صار مع فولان في بيلاروسيا؟ شو صار مع تقديم تأشيرة فولان؟ قدر فولان يلتقي مع أمّه المريضة يلي ساكنة في بلد تانية؟ هل فولان وصل لسوريا؟ لأوروبا؟ ليش ما طمنّي؟ وينه؟ كيفه؟ كيف أهله؟ شو رح يصير لما فولان يسافر؟ شو رح يصير إذا فولان ما يقدر يسافر؟
وأعود للمحادثة...
11 سنة مرت منذ بدأت الثورة السورية، وسنة ونصف مرت منذ بدأت أتابع قصص الناس الذين جاءوا بسببها إلى الأردن. ولوهلة أشعر أنني تائهة. كأني نسيت مهمتي، دوري. لكن ما هو دوري كباحثة ضمن هذا المجال؟ أسمع قصص الناس؟ أتعلم منهم؟ أوصّل صوتهم؟ أساعدهم؟ وبغض النظر عن دوري، هناك سؤال آخر عالق في رأسي دائمًا، ما هي الفائدة من هذا الدور؟
لو كنت وردية أو "موضوعية"، لم أكن لأتـخيل الإحباط عندما ترفض سفارة تأشيرة شخص ما، من سفارة ما، مرة ومرتين وثلاث. لم أكن لأتخيل الحزن عندما يتحدث الناس معي عن التعب أو اليأس الذي يشعرون به. ولم أكن سأشعر بالإحراج والذنب من حقيقة أن هذه في النهاية حياة ناس آخرين، لا حياتي.
ليش صافنة يا هانا؟
لست وحدي. ليست عيوني فقط التي تبدو شاردة وفارغة من وقت إلى آخر. أصحاب هذه القصص أيضًا.
خلال مقابلة.
خلال تحضير أوراق.
رسائل.
تقديمات.
مخططات.
خلال دردشة يومية عادية.
خلال جلسات لطيفة معي أو مع غيري.
وكما أعود أنا، يعودون هم، إلى المحادثة.
ليش صافنين؟
إلى أين أخدتهم أفكارهم؟ إلى الماضي؟ إلى الحاضر؟ إلى المستقبل؟ إلى مكان معين؟ إلى شخص معين؟
كيف يمكن أن نكون موضوعيين؟ كيف يمكن اعتبار عدم الانخراط في أوجاع الناس وقضاياهم أكثر مصداقية، وكيف يمكن للحياد البارد أن يحظى بشرعية علمية أكبر؟
هناك مقولة في العربية تقول "الحياة حلوة بس نفهمها". مقولة مأخوذة من أغنيّة لفريد الأطرش صارت دارجة بين الناس. ومن خلال دراستي الميدانية هذه السنة، حاولت أن أفهم حياة السوريّين في الأردن. لكن كل يوم، كل أسبوع، كل شهر وبعد كل مقابلة، محادثة، دردشة، وبعد كل محاولة، صار أصعب علي أن أفهمها. فأسأل نفسي، ما الذي أتى بي إلى هنا، إلى هذا الموضوع؟ إلى هؤلاء الناس؟ لا أعرف. لا تبدو "الحياة حلوة" هنا، لكننا لا نزال على الأقل نحاول فهمها.
تود الكاتبة أن تشكر على المساعدة في إعداد هذه المادة كل من: إيناس الأسد، مصعب صالح، أماندا ليندهولم، عز الدين أعرج.