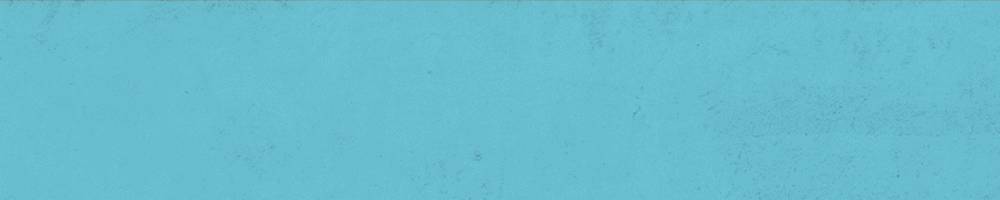صبيحة اندلاع المواجهات المسلحة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في الخرطوم، لم تفزعني أصوات الاشتباكات التي انطلقت بالقرب من منزلي جنوبي العاصمة أكثر من أنها أثارت في الفضول، فمنذ سنوات والخرطوم في حالة حرب غير معلنة، والفزع يحتاج لعنصر المفاجأة، بينما كان الجميع يترقب هذه الحرب التي بدت مظاهرها على كل شيء منذ سنوات في بلادي.
ولكني مثل جميع السودانيين لم أكن مستعدًا لها، فنحن يداهمنا كل شيء حتى المواسم والفصول، ويتندر السودانيون كل عام كيف فاجأهم الخريف؟ وبطبيعة الحال ذلك ليس نتيجة لعدم توقعنا لهذه الأحداث الراتبة، ولكن من خصائص الهدر والقهر الإنساني الذي استطال في أرض السودان، عدم تملك الإنسان لمصيره، فالسيطرة على المصير تحتاج أن يكون باليد حيلة، وهي بعض ما يسلبه القهر منا، على الرغم من محاولاتنا المستمرة لاستعادة ذلك المصير، وليست آخر تلك المحاولات الثورة السودانية التي كانت ما تزال تمور في شوارع الخرطوم، وربما ذلك ما دفع بأجهزة القهر للاقتتال.
من خصائص الهدر والقهر الإنساني الذي استطال في أرض السودان، عدم تملك الإنسان لمصيره، فالسيطرة على المصير تحتاج أن يكون باليد حيلة، وهي بعض ما يسلبه القهر منا، على الرغم من محاولاتنا المستمرة لاستعادة ذلك المصير، وليست آخر تلك المحاولات الثورة السودانية التي كانت ما تزال تمور في شوارع الخرطوم، وربما ذلك ما دفع بأجهزة القهر للاقتتال.
علمت بعد اندلاع الاشتباكات بدقائق من زميل في العمل أنها اشتباكات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. لم تكن أصوات الرصاص الذي يحلق فوق بيتنا مخيفة أكثر من أنها ربما تغير من روتين يومي الراتب، لأن الحرب في بلادي "جرح طفيف على ذراع الحاضر العبثي" هناك، فقد اعتدنا على العنف الغاشم منذ نعومة أظافرنا. ولذلك لم يكن بديهيًا أن نغادر الخرطوم فورًا، ولم نشرع بذلك إلا بعد أيام من بداية الحرب، وقد رجحت كفة خيار المغادرة، كي نستغلها لنحضر العيد مع العائلة الممتدة في "بيتنا الكبير" بولاية كسلا شرقي البلاد.
كل شيء كان عاديًا في الخرطوم التي تجولت فيها والحرب مستعرة بحثًا عن وقود لرحلتنا خارج المدينة، وكل شيء كان عاديًا في كسلا التي وصلتها بعد رحلة صعبة -كالعادة- مررت فيها بولايتي الجزيرة والقضارف - حسنًا ربما "عادي" كلمة لا تناسب السودان، ما أقصده هو أن الواقع كان به تلك المسحة من الاعتيادية التي يسبغها العجز على الأشياء، فليس غريبًا ما لا يمكن تغييره، بل يصبح شرطًا كالزمان والمكان، شيء لا بد منه.
في الخرطوم والولايات كان الجميع يتحدث عن الحرب كحديثهم عن الطقس، ويسعون في حيواتهم اليومية التي لم تزد الحرب في تعقيدها الراسخ الكثير. لم تأتِ الحرب بجديد يذكر في السودان: قطوعات الكهرباء هي نفس قطوعات الكهرباء، غياب الخدمات هو نفس غياب الخدمات، الناس لم تحس بانهيار الدولة لأن الدولة لم تكن هناك أصلًا، يشترون المياه للاستخدام المنزلي من سنوات طويلة، ويتحملون حر الصيف في جلد، وما يزال المسلحون يقتلون المدنيين في الشوارع.
يقول الشاعر الفلسطيني الكبير مريد البرغوثي في "رأيت رام الله" إن اللاجئين في نكبة 1948 لجأوا إلى البلدان المجاورة "كترتيب مؤقت". "تركوا طبيخهم على النار آملين العودة بعد ساعات"، أما أنا فمثل العديد من أبناء جيلي الذين أحبطتهم صعوبة التغيير في السودان؛ كنت أجهز لمغادرة بلادي منذ فترة ليست بالقصيرة. "الهجرة" لم تكن خطة جديدة، ولكن الحرب حسمت لي مسألة المواعيد بعنف إثر سنوات من المماطلة، إذ لا يسمح الوضع في شرقي السودان الذي تنعدم فيه جميع سبل الحياة بمواصلة عملي وطموحي الدراسي، وكذلك لم تعد الخرطوم التي تركزت فيها الخدمات -على شحها- آمنة، فيممت وجهي صوب الحدود لا ألوي على شيء.
في طريقي إلى خارج البلاد وخلف الحدود التقيت العديد من المعارف والأصدقاء، كما تعرفت بآخرين، صرنا مجموعة كبيرة جمعتها الزمالة في هذه المهمة، ولكن كل من التقيته كان يحاول جهده نفي وصف نازح أو لاجئ عن نفسه، ويختلقون الأعذار غير الحرب لمغادرتهم البلاد كما فعلت أنا في الفقرة السابقة، و لربما هذا الإنكار ليس إلا آلية دفاعية نحمي بها أنفسنا حتى لا ننهار قبل إكمال هذه الرحلة الجحيمية من نيران الخرطوم لنيران الغربة خلف الحدود.
ولكن رويدًا رويدًا يمر اللاجئ منا بمراحل الصدمة النفسية الخمس، فبعد هذا الإنكار يأتي الغضب، وقد غضبنا على من كانوا سببًا في هذا المصير، ولعناهم كثيرًا في جلساتنا في ليالي المدن الغريبة، كما طمأنا بعضنا البعض بخير طال انتظاره في المهجر بالتقدم في العمل والدراسة بعيدًا عن اضطراب السودان الكفيل بتخريب أية خطط وإرباكها، مساومين بمراتع الصبا ومصابحة الأهل والأحباب. كما بدا واضحًا لي أن أيًا منا لم يكن يحب أن يخلو بنفسه، حتى لا تنتهز أسئلة المصير الجالبة للكآبة، فرصة الوحدة الأصيلة في معنى الغربة.
ولكننا كسودانيين لا أعتقد أننا سنتقبل في يوم ما ما آل إليه الحال فينا وفي بلادنا، خصوصًا بعد كل تلك التضحيات الجسيمة والمدافعات المحتدمة، وليس أدل على ذلك من استمرار الاحتجاجات الشبابية لسنوات ضاهت الخمس وزيادة بلا توقف رغم تفنن آلة القتل في إعمال أجهزتها فينا بشتى السبل، وما زلنا نقاوم.