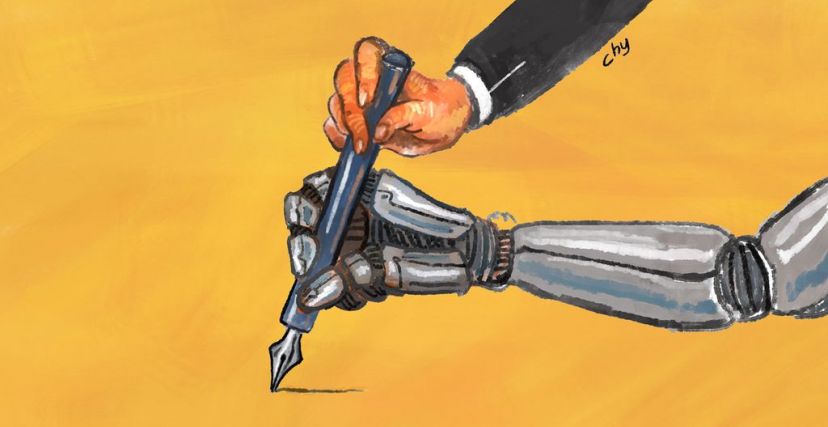"الثورات الكبيرة للصحافة ليست ثورات في الرأي العام، بل ثورات في الطرق التي يتشكّل فيها الرأي العام"
آرشيبولد ماكليش
تتراكم الأدلة والإرهاصات التي تنبّهنا إلى أن التغييرات الحاسمة والأكثر تأثيرًا في حياة الناس والمجتمعات هي تلك التي تحصل عادة على الصعيد الاجتماعي والسياسي، لا التقني. رغم ذلك، لا يكاد يحاز موضوعٌ من الحضور والزخم في الإعلام العالمي ووسائط التواصل اليوم مثلما يحوزه موضوع الذكاء الاصطناعي. ففي مطلع الشهر الجاري، وعبر برنامجه الأسبوعي على شبكة "سي أن أن"، تحدّث فريد زكريا ببلاغته المعهودة وصوته الفخيم عن "وعود الذكاء الاصطناعي ومخاطره" فجلب إلى برنامجه كلًا من جيفري هينتون وإريك شميدت، أبرز وأقدم المختصين في المجال وأشدّهما تشاؤمًا إزاءه. فجيفري هينتون، أبو الذكاء الاصطناعي كما يقولون، لا تفارق خياله الخصب سيناريوهات نهاية العالم، حين تسيطر الروبوتات الفائقة على البشر وتنقلب علينا بعد أن تنجح في التواصل فيما بينها عبر لغة مشتركة خاصة. أما شميدت، الرئيس التنفيذي السابق في جوجل، فيخشى تلك اللحظة التي يتمكّن بها "أسامة بن لادن جديد" من تطوير سلاح جرثومي فيقضي به على ملايين البشر. آخرون من الكتّاب والصحفيين أعلنوا أن أثر الذكاء الاصطناعي وتقنياته لن تكون أقل مما كان لأثر اكتشاف البارود أو المحرك البخاري في تاريخ العالم في الحقب الحديثة، رغم أن الأمر في نظر كثيرين، ليس في أصله و/أو نتائجه سوى فصل جديد تتأبّد فيه الشروخ بين أولئك الذين يمتلكون هذه التقنيات ويحكمون السيطرة على تطويرها ودوام احتكارها، وبين آخرين بالكاد تتجاوز دولهم المراتب الدنيا في مؤشرات التنمية ومعدلات الدخل والحريّات السياسية والعامة، أو شعوب بالكاد تتيسّر لهم سبل المعاش الكريم الأساسيّة.
هذه الحالة الراهنة التي تراوح فيها التقنيات الجديدة، ومنها نماذج الذكاء الاصطناعي، بين تقديم حلول لمشكلات قديمة ضمن شروط استخدام غير منصفة، وبين خلق مشاكل جديدة ناجمة عن التباينات الواسعة في تطويرها أو تطبيقها أو التحيزات الكامنة بها، والإصرار فوق ذلك على الترغيب بها باعتبار أنها شرط للتنمية والتحديث، أو الترهيب منها في تمارين ذهنيّة سمجة مكيّفة للاستهلاك الإعلامي الرخيص، تتجلّى بشكل واضح في مجالات التواصل والتعليم وإنتاج المعرفة وتوليد المعلومات والترفيه، وهي أنشطة تتأثر بطبيعة الحال بالأنساق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تحدث ضمنها، كما ينبغي تفسيرها ضمن هذه الأنساق وخصوصياتها.
ويبدو أن كل منعطف تقني حادّ يشحذ انتباه الخبراء والناشطين والباحثين وينبّه إلى ضرورة فهم المنطق التي تقوم عليه الأدوات التقنية الجديدة وطبيعة مخرجاتها، ولاسيما حين تطرح في سياق من فرط العولمة. فمنذ سبعينات القرن الماضي، وبالتحديد بعد أزمة النفط العالمية عام 1973، تصاعدت المطالبات في الجنوب العالميّ بإعادة النظر في النظام الاقتصادي القائم ورفض هيمنة الولايات المتحدة عليه، كما ارتفعت الأصوات العاقلة المحذرة من آثار المركزية الغربية في "توليد المعلومات وتوزيعها"، وذلك بحسب ما تنقل آسا بريغز وبيتر برك في كتابهما "تاريخ اجتماعي لوسائط التواصل: من غوتنبرغ إلى الإنترنت" (صدرت ترجمته عن هيئة البحرين للثقافة عام 2017، ونقله إلى العربية بترجمة بديعة الدكتور السوري نور الدين شيخ عبيد). في تلك الفترة عينها، برز أيضًا مطلب "السيادة الثقافية" في مقابل "الهيمنة الثقافية" الأحادية، والتحذير مما تتيحه تقنيات الاتصال الحديثة من الانفاصل بين المكان الفعلي لإنتاج الثقافة ومدى وصولها وتأثيرها.
في ذلك السياق وفي ظروف الحرب الباردة، تشكّلت بتوجيه من اليونسكو لجنة من المختصين (كان من ضمنهم مارشال ماكلوهان، والروائي الكولمبي ماركيز والسياسي الإيرلندي الشهير شون ماكبرايد، المتوج بجائزة نوبل للسلام عام 1974)، وأخذت على عاتقها وضع تقرير طموح يسعى لمعالجة استغلال بعض "الدول المتقدمة لجوانب تفوقها [التقني] من أجل ممارسة نوع من الهيمنة الثقافية والأيديولوجية التي فيها مساس بالهوية الوطنية لدول أخرى". يندرج في هذا الاستغلال مثلًا ما وصفه التقرير بأنه تشويه لصور الدول النامية على حساب الدول المتقدّمة، وإمعان الآلة الإعلامية للدول المتقدّمة على وصف الأوضاع المتخلفة في الدول الأخرى والتركيز على ما فيها من مشاكل وكوارث وجريمة وفقر، وافتقار التغطية الإعلامية (عبر الأقمار الصناعية حينها) إلى التوازن في حجم المعلومات وجودتها، وأنه قد يترتب على ذلك ردود فعل متطرّفة، حين يدفع بعض الحكومات والأنظمة السياسية إلى اتخاذه ذريعة من أجل فرض رقابة وسيطرة محليّة على المعلومات ومنع تدفقها من خارج حدودها، باعتبار أن الاستقلال الكامل والسيادة يفترضان استقلال وسائط الإعلام واتساقها مع مقتضيات ذلك، وأن ذلك في المحصّلة يقوّض الديمقراطية والحريّات العامة.
كان تقرير اللجنة، المعروفة بلجنة ماكبرايد، والذي انقضى على صدوره زهاء 44 عامًا، تقريرًا ثوريًا في طموحه أمام فداحة المشاكل التي سبرها واستعرضها، والآراء التي كانت يومذاك صدى لخطاب الدول في مرحلة ما بعد الاستعمار والاصطفافات المعروفة إبان الحرب الباردة، وهو ما حكم بالعقم سلفًا على مخرجاته عندما صدر عام 1980، وتحفظ الولايات المتحدة وبريطانيا على توصياته ومحاولة النيل من رئيس اللجنة نفسه وتشويه سمعته. كان من أبرز التوصيات التي تضمنها التقرير "أن تعمل الصحافة على تعزيز حق الشعوب العادل في النضال من أجل الحرية والاستقلال، وصون حقها في العيش بسلام ومساواة دون تدخّل أجنبيّ"، وكذا "النضال ضد الاستعمار والتمييز على أسس دينية وعرقية". كما اشتملت التوصيات على ضرورة عمل الصحافة على "تعزيز الهوية الثقافية" والإحجام عن الترويج "لصور مشوهة" عن المرأة، مع التأكيد على أهمية مواجهة الوصاية والرقابة الحكومية. أما التوصية الأكثر إثارة للجدل في التقرير، فكانت تلك المتعلقة بدعم الأنماط غير التجاريّة في وسائل الإعلام الجماهيرية، والعمل على "الحد من الآثار السلبية لتأثير منطق السوق والاعتبارات التجارية على المحتوى الإعلامي"، وهي توصيات اعتبرها المسؤولون الأمريكيون والبريطانيون تتماهى مع أيديولوجيا المعسكر الشيوعي.
الحاجة إلى "ماكبرايد" جديد
على اعتبار أن المجادلة ضد الاستعمار بأشكاله المختلفة لم تنته في العالم بعد، واعتبار الإقرار شبه البديهي السائد بأن للصحافة دورًا أساسيًا في تفكيكه أو إعادة إنتاجه، فإن الحاجة ما تزال قائمة إلى مبادرة عالميّة مماثلة في جرأتها وموقفها النقديّ من تغوّل السلطة والارتهان لرأس المال والتشابك المعقّد بينهما، بل وأشدّ ضرورة اليوم من أي وقت مضى في ظل الانتكاسات التي تعاني منها الديمقراطية وقيمها وصعود النظم الشعبوية في دول عديدة حول العالم. فالصحافة نفسها اليوم تتحرّك أساسًا في ملعب وسيط مهيمن، هو المنصّات الرقميّة، التي باتت ترهن وصول المحتوى بالخضوع لشروط سوقها هي ومقتضيات مصالحها هي، الأمر الذي يضاعف أثر"فلتر" إيرادات الإعلانات على العمل الصحفي، بحسب نموذج "البروباغاندا" الذي وضعه تشومسكي وهيرمان عام 1988، والذي ما يزال يوفّر حتى اليوم عدّة تحليليّة مفيدة لفهم أزمة الصحافة حتّى في العصر الرقمي (في الدول الديمقراطية أو شبه الديمقراطية، أما في سياقات غير ديمقراطية، فالأمور أشدّ بساطة، حيث عسف السلطة هو "الفلتر" الاعتباطي الأساسي الضابط لسقف التوقعات من الصحافة وأهلها).
وضمن هذه الحالة من التشكّك المعقول والسخط الضروري، يمكن هضم السؤال المتعلق بالذكاء الاصطناعي والصحافة اليوم، ومقاربة ما يدور حول هذه المسألة من نقاشات قد تكون مفيدة نظريًا و/أو عمليًا، ولاسيما عند تلقي ومراجعة التقارير والاستبيانات العديدة التي تعنى بهذه الظاهرة في الآونة الأخيرة. فالإقرار بأن الصحفي يعاني مشكلات جوهريّة في عمله (سياسيًا وماديًا ونفسيًا)، مع التذكير أيضًا بأن هذه المشكلات تتباين تباينًا كبيرًا بين صحفيّ صاحب امتياز وحظوة، وبين آخر يقطن في دولة سلطويّة يخشى الاضطهاد من سجن أو تغييب، قد يكون تمهيدًا منطقيًا لا غنى عنه، يمنع الخوض بعيدًا في سيناريوهات تكاد تقترب من عالم الخيال والعبث، ولا فائدة لها حتى نظريًا، إذ تكاد تشبه بيع السمك وهو ما يزال في الماء، وهو فوق ذلك قد لا يكون صالحًا للأكل أصلًا.
وهذا ما يبدو أن القائمين على مشروع "الذكاء الاصطناعي في الصحافة" التابع لكلية لندن للاقتصاد، قد فطنوا إليه جيدًا، إذ أدركوا أنّه لن يكون في جعبتهم الكثير لتقديمه أمام جماعات الصحفيين في بلدان الجنوب، كما يحلو للتقرير وصفهم، إن هو تحدّث إليهم بلغة لا يعنيهم فهمها والانخراط بها، وهي بالتأكيد ليست لغة التقنية والذكاء الاصطناعي. ولعل هذا ما يجعل التقرير يفترق عن مبادرات عديدة سابقة قريبة في النطاق وشقيقة في التمويل، مثل تقرير معهد رويترز للصحافة الرقمية، والذي يتجاهل خصوصيات الحالة الإعلامية في الدول المختلفة، ويتعامل معها وكأنها امتداد لمركز حصري الامتيازات لا أطراف له ولا هوامش.

أما تقرير الذكاء الاصطناعي في الصحافة، الصادر في أيلول/سبتمبر الجاري، فيعتمد على استطلاع عالمي واسع، شاركت فيه 105 مؤسسات صحفية وإعلامية من 46 دولة، من بينها عدة دول عربيّة، بالإضافة إلى دول أفريقية ولاتينية وآسيوية أخرى، وقد استدعى نطاق الإجابات وتنوعها بحسب القائمين على التقرير إضافة فصل تحليلي جديد، خلا منه تقرير العام الماضي، يركّز على استكشاف الهواجس الأساسية التي تسود بين الصحفيين في هذه المناطق عند الحديث عن الذكاء الاصطناعي وصنعة الصحافة.
وانطلاقًا من تفهّم هذه الخصوصيّات، يستهلّ التقرير خلاصته التنفيذية بالإقرار الأوليّ بأن "تقنيات الذكاء الاصطناعي ما تزال غير متاحة على نحو عادل بين غرف الأخبار بحسب حجمها أو بحسب مكان تواجدها بين بلدان الشمال والجنوب". إن هذه الجملة الافتتاحية تفرض نبرة مسؤولة متحررة من الرقابات المتوقعة، تعترف بانقسام العالم المتزايد بين مركز يحتكر الامتيازات ويراكمها وأطراف مهمّشة، وهي انقسامات وشروخ يرى التقرير أنها ليست مناطقية أو جغرافية، بل هي إشارة إلى الوضع القائم من "تباين القوة والثروة بين دول العالم". فبلدان الشمال تضم دولًا في نصف المعمورة الجنوبي، كأستراليا ونيوزلندا، وهي تضم دولًا آسيوية مثل اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة. أما الجنوب فيضم دولًا من أرجاء من المعمورة كانت خاضعة للاستعمار، وما تزال تعاني من تبعاته الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، حتى بعد تحقيق الاستقلال الوطني، بحسب ما يذكر ذات التقرير. (ص65).
أما البند الثاني من الخلاصة التنفيذية، فيشير إلى أن جلّ المنافع الاجتماعية والاقتصادية لتقنيات الذكاء الاصطناعي "متركّزة في [بلدان] الشمال العالمي، والتي تحظى بالبنى التحتية والموارد، في الوقت الذي تعاني منه الدول في الجنوب العالمي من التداعيات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للاستعمار حتى بعد الاستقلال عنه".
على هذا النحو وبهذه المفردات يبادر التقرير إلى الاعتراف بلا مراوغة ولا تحفّظ بوضع العالم كما هو قائم اليوم، وهو عالم تمتلك فيه الدول المتقدّمة عناصر القوّة ومقوّمات الهيمنة على حساب دول نامية تمتلك هي فيه الأغلبية في عنصرها البشري، ولكنها أغلبية "مُضعفة ومُبعثرة" في بناها الحيوية الأساسية. فالتقرير بصفحاته التسعين يتضمن فوائد عديدة، ويوفّر مقدّمات مبسّطة لا غنى عنها لفهم بيئة الذكاء الاصطناعي توضح اصطلاحاته المفتاحية وتسبر جوانبه ذات العلاقة بالمجال الصحفي، وأوجه استخداماته في غرف الأخبار الحديثة، والإستراتيجيات المتبعة في ذلك، وما يستتبع ذلك كلّه من أسئلة أخلاقية عملية على مستوى الجودة وسلوك الخوارزميات ودور شركات التقنية والإنترنت والمعاهد البحثية والمؤسسات الرسمية والتقاطعات العديدة بينها في هذا الصدد. ومع ذلك، وعبر البندين الأوليين في الملخص التنفيذي، والتوسع اللاحق في بيانهما، يتيح التقرير لأمثالنا من القراء الانتقال إلى فصله السادس الذي حمل هذا العنوان الدالّ: "التباين العالمي في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي واعتمادها"، وهو فصل أساسيّ لكل صحفيّ يجد نفسه على تخوم هذه النقاشات التقنيّة وحسب، نافرًا من الانخراط بها دون بناء موقف نقدي واعٍ منها.
الذكاء الاصطناعي والصحافة.. كلام الجنوب والشمال
ماذا يخبرنا الفصل السادس إذًا في هذا التقرير عن الذكاء الاصطناعي والصحافة بين عالمي الشمال والجنوب، وما الذي تقوله الأصوات القادمة من هناك عن الشروط التي يجدر تحققها قبل الحديث على نحو معقول عن موقع هذه التقنيات في غرف الأخبار أو في أعمال الصحفيين الدورية الناشطين في دول لا تملك سوى الاستيراد السلبي لها؟
يشير التقرير إلى أن المستجيبين للاستطلاع من مؤسسات إعلامية في بلدان الجنوب العالمي (وكنا في شبكة التراصوت جزءًا من هذه المجموعة) قد نبّهوا جميعًا إلى الفجوات المعرفية المتعلقة بهذا المجال الناشئ، وعدم توفر الموارد والأدوات المحليّة ذات الفعالية المجرّبة، وضعفها على مستوى الاستجابة اللغوية والبيانية في اللغات غير الإنجليزية (كالعربية)، إضافة إلى التحديات الأساسية القانونية والسياسية التي تحول دون استفادة الصحفيين من تطبيقات الذكاء الاصطناعي على النحو الذي يجري الحديث عنه في سياقات أخرى.
أحد المستطلعين من إحدى الدول العربيّة أشار إلى استحالة الاستجابة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي في المنطقة، في ظل الأوضاع السياسية القائمة فيها وما يرتبط فيها من تدهور اقتصادي واجتماعي. فما يزال الملايين من سكان المنطقة يعيشون في ظروف لجوء ونزوح بسبب النزاعات والقمع، كما أن الصحفيين يواجهون ظروفًا استثنائية حتّى في الحيّز الرقمي الذي يفترض أن يكون أكثر انفتاحًا، وذلك بسبب ضعف خدمات الإنترنت وهيمنة الدولة السلطوية وأدواتها الرقابية والإعلامية، وهو الأمر الذي يعمّق حالة "الهدر" الرقمي على مستوى المعرفة وتوليد المعلومات والتعبير عن الآراء ووجهات النظر المتعددة والوصول إليها بين عموم المستخدمين في المنطقة.
تشير الملاحظات التي تخللها هذا الفصل من التقرير إلى أن موضوع الذكاء الاصطناعي واعتباره "فرصة" للصحفيين لا يعدو عن كونه متخيلًا نظريًا بعيدًا عن متناول الغالبية العظمى من سكان العالم، وهي حالة لا تعني أن هذه "الفرصة" ضائعة وحسب، بل تعني أيضًا أن الأطراف المستفيدة منها على المقلب الآخر ستواصل تفوّقها وتوجيه ما لديها من قدرات تقنية عمليّة لبسط تجربتها واتجاهاتها على الآخرين، وهي حالة تذكّر بأن حلول الذكاء الاصطناعي أبعدَ ما تكون عن الحياد والعالميّة، وأن للسياقات المحليّة المختلفة متطلبات ما تزال خارج اعتبار نماذج هذه التقنيات وخوارزمياتها، ولاسيما على مستوى اللغة والبيانات والخبرات التقنية. فابتكار مثل هذه الحلول المتقدّمة وتطبيقها يتطلّب تخصّصًا محليًا بها، وهو شرط غير متاح في القطاع الصحفي في الدول غير المتقدّمة، حيث ضعف تمويل المؤسسات الصحفيّة الذي يعني من مجمل ما يعنيه أنها لن تكون الوجهة المفضّلة لخبير في الذكاء الاصطناعي للعمل فيها، هذا لو افترضنا وجود بنية تحتية أساسية تتيح العمل على تطوير حلول أو تكييفها في هذا المجال وللصالح العام بعيدًا عن عسف السلطة واشتراطاتها. فالشركات التقنية الكبرى تضع استثماراتها في الأسواق الغربية، حيث الجامعات المتطوّرة والمعاهد البحثيّة المتخصّصة ذات التمويل الضخم والتي تعمل غالبًا على أدوات تعتمد على نطاق هائل من البيانات المتوفّرة باللغة الإنجليزية، والتي تعدّ لغة نماذج الذكاء الاصطناعي الأولى بلا منازع.
ومن المعلوم أن لهذا الأمر تبعات عويصة، يعرفها الصحفيون والعاملون في حقول إنتاج المعرفة ويختبرونها باستمرار، وهو ما يدفعهم وآخرين إلى التحذير منها كلّما سنحت الفرصة. فثمة اعتراف واسع كما أسلفنا باستحالة أن يكون لنموذج توليدي واحد فائدة عالميّة لجميع المستخدمين، مثل "تشات جي بي تي" أو نموذج "بارد" من جوجل، ومغبّة ذلك لو حصل، وأن الفائدة ستكون محدودة أكثر لصحفيّ أو كاتب بلغة غير الإنجليزية، وهو ما أشرنا إليه مرارًا في مقالات سابقة. أما في حال بروز نماذج محليّة للذكاء الاصطناعي التوليديّ، فإن هذا لا يعني حلًا تلقائيًا مضمونًا، بل ربما يوسّع نطاق المشاكل التي يجدر الحذر منها، لاعتبارات تقنيّة بحتة من جهة، ولاعتبارات سياسية واجتماعية من جهة أخرى.
يسجّل التقرير هذه الحالة من الريبة الحصيفة، كما عبر عنها صحفيون وصحفيات في بلدان الجنوب العالمي، من تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يجري تطويرها في دول سلطوية ذات سجلّ معاد للديمقراطية وحقوق الإنسان أو بتمويل منها. فالارتباط الوثيق بين الشركات التقنية المحليّة والسلطات الرسميّة يحول دون افتراض الثقة بالمنتجات والحلول التقنية التي توفّرها (ص 70)، أو افتراض إمكان دعمها لأي مشروع صحفي مستقلّ قد يمتلك موقفًا ناقدًا من السلطة. وفي حين أن التقرير يشير إلى نموذج "علّام" السعوديّ الذي لم يطرح للاستخدام بعد، إلا أن تجربة عمليّة برزت مؤخرًا في الإمارات العربية المتحدة، عبر نموذج "جيس" للذكاء الاصطناعي، قد أكّدت هذا الشكّ المعقول في وجود أجندة يلتزم النموذج بها أو يطمح للترويج لها في عدد من القضايا الإشكالية، وهو ما تناولناه في مراجعة تفصيلية سابقة.
عالم واحد.. أصوات متعددة
إن المقاربة الجريئة التي تضمنها تقرير "الذكاء الاصطناعي في الصحافة" والصادر عن أحد أهم المعاهد الأكاديمية في العالم، والتي تعود إلى أسئلة أساسية قديمة جديدة حول السلطة والاستعمار والتقنية والسلطوية والتقاطعات بينها، تجدّد الأمل في إمكان تطوير أطر نقدية أوسع للتحليل والنقاش والمراجعة، حتى في مواضيع تبدو ناشئة كالعلاقة بين الصحافة والذكاء الاصطناعي. ثم إن هذا الموقف المبدئي يبدو راسخًا وغير طارئ، وذلك أنّه امتداد لنقاشات طويلة حايثت كل ثورة تقنيّة ومعلوماتية، كان منها ما ورد في تقرير لجنة "ماكبرايد" (عالم واحد.. أصوات متعددة)، المذكور أعلاه، والذي أختم مقالي هنا بالعودة إليه. ففي أحد التعقيبات الملهمة في ذيل ذاك التقرير المنسيّ، يحذرنا الروائي/الصحفي الراحل غابرييل ماركيز، بواقعيّة صارمة، من الميل إلى "تمجيد" الحلول التقنية والمبالغة في تقدير دورها في حل مشكلات التواصل وتبادل المعرفة في العصر الحديث، إذ نادى بضرورة التأكيد على أن "الوعد التقني ليس محايدًا ولا متجردًا عن القيمة، وأن للتطورات في هذا المجال تبعات سياسية واجتماعية هائلة". يخبرنا ماركيز أيضًا بضرورة الترفّع عن "الوصاية التقنية" والتنبّه إلى أن أية خطة يجري السعي إلى فرضها بدعوى تطوير البنى التحتية التقنية في العالم الثالث سيتجاوز ضررها نفعها على المجتمعات المحلية، إذ إنها خطط تميل عادة إلى "إعادة إنتاج القيم الغربية وتقديم المصالح فوق الوطنية على مصالح تلك المجتمعات"، وأن مثل هذه المبادرات قد تُقبل بشرط التبيئة المحليّة لها، وبما يضمن عدم توظيفها في توطيد قواعد السلطة غير الديمقراطية، أو ترسيخ حالة غير صحيّة من الهيمنة الثقافية والاقتصادية، تمنع أي إمكان للتناظر الحضاري.
لقد استشرف ماركيز ورفاقه في اللجنة هذه الحالة التي يختلط بها العجز مع الاضطراب على المستوى الفردي والاجتماعي إزاء التقنيات الجديدة والتحمس المفرط لها، وشرح كيف أن احتكار التقنية يعيق أي تطوّر قبل البدء به أو ينتهي إلى تشويهه، وهذا في تقديري ما نجح الفصل السادس من تقرير كلية لندن للاقتصاد على الأقل، بالتذكير من جديد به، في سياقٍ سياسي عالميّ معقّد ينثر من العقبات أضعاف أضعاف ما يقترح من حلول.